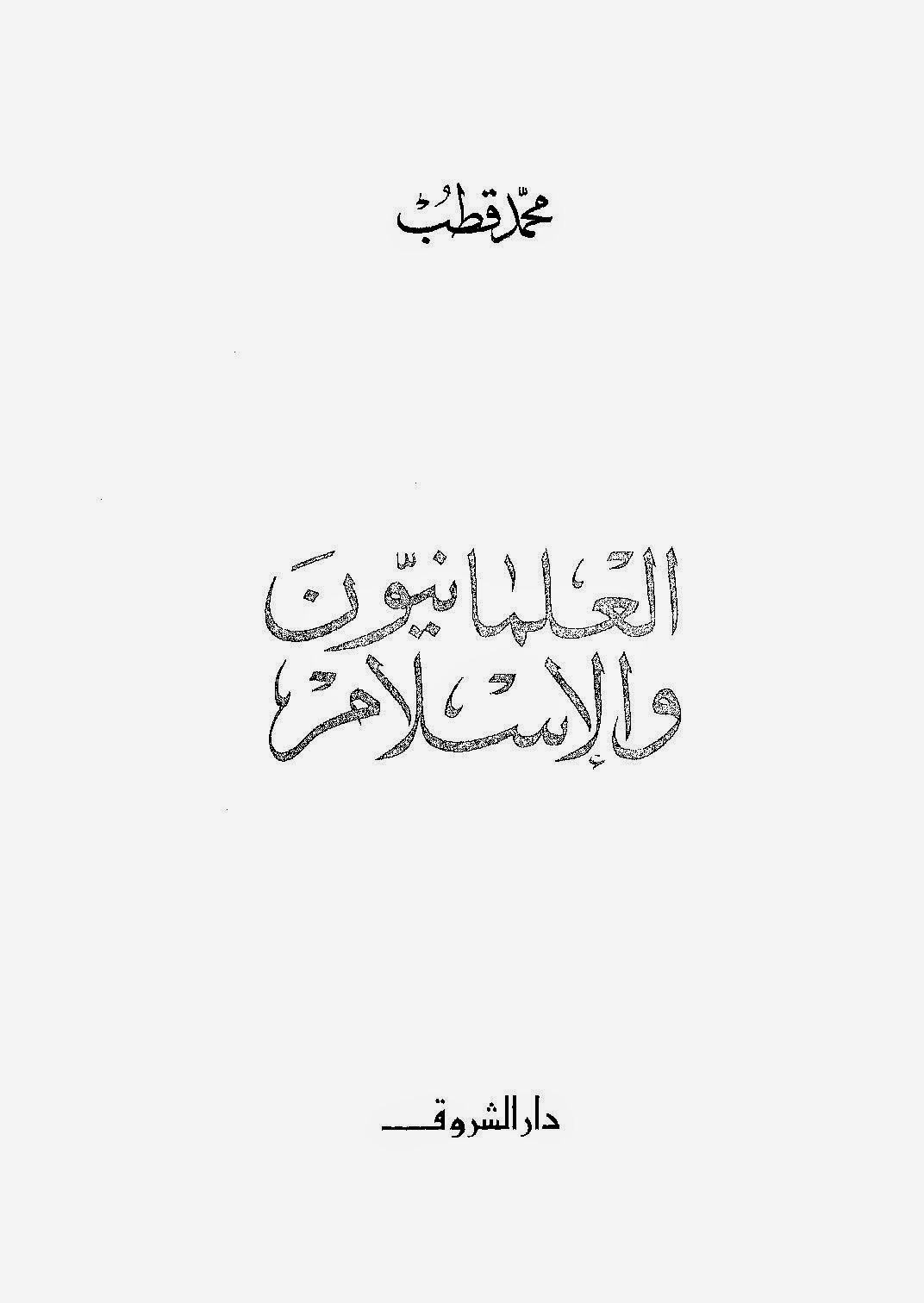ثقف نفسك بخطة قراءة من ملخصات كتب المعرفة المهمة
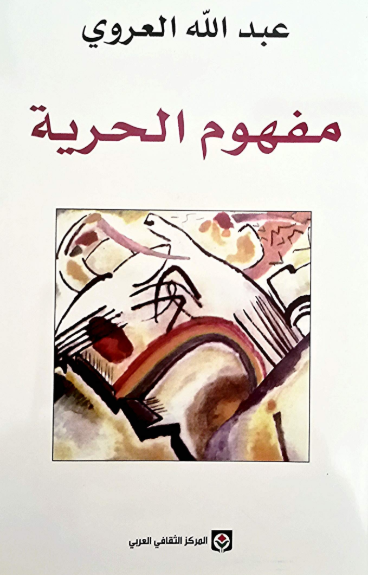
ملخص كتاب مفهوم الحرية
الحرية في التراث
عبد الله العروي
يعتبر مفهوم "الحرية" من أبرز مفاهيم الحداثة في العصر الحديث؛ ولذلك نحن من أنصار القطيعة المعرفية مع التراث "العربي/الإسلامي"، وندعو إلى تبني قيم الحداثة "الغربية" باعتبارها قيم إنسانية، وندافع عن التوجه التاريخي باعتباره معبرا عن "وحدة" و"تقدم" الإنسانية، وعن الماركسية في صورتها الفلسفية الحداثية - حتى أن عنوان أحد كتب مشروعنا، وهو أوّل مفهوم لسلسلة المفاهيم، يدعى بمفهوم العقل. ونظرا لكون من بين المفاهيم؛ مفهوم الحرية، والذي له مكانة بارزة؛ لأنه لا دولة إلا دولة الحرية ولا عقل إلا العقل الحر وهو ما سيدور حوله حديثنا.
1- طوبى الحرية في المجتمع الإسلامي التقليدي
إن كلمة حرية في اللغات الأوروبية كانت عادية لدى الغربيين في القرن التاسع عشر، والمفهوم كان بديهيا إلى حد أنه لا يحتاج في الغالب إلى تعريف. أما علماء وفقهاء الإسلام، فإنهم كانوا لا يستعملون عادة الكلمة التي لم تعرف رواجا إلا كترجمة اصطلاحية للكلمة الأوروبية، وكانوا كذلك لا يتمثلون بسهولة ودقة مفهوم الحرية.
نبدأ بالفحص اللغوي ونستخرج من هذا العرض فائدتين: الأولى أن الصيغة المألوفة هي الصفة ومشتقاتها : حر، محرر، تحرير. أما المصدر الأصلي: حرية، فأنه يستعمل للتمييز بين من كان حرًا من الولادة وبين من كان عبدًا ثم أعتق. والفائدة الثانية هي أن المعاني الأربعة تدور حول الفرد وعلاقته مع غير ذاته، أكان ذلك الغير فردا آخر يتحكم فيه من الخارج أو قوة طبيعية تستعبده من الداخل.
إن المجتمع الذي يصوره لنا الفقه مجتمع مجزأ إلى أحرار ورقيق، ينقسم فيه الأحرار إلى أكفاء ومحجورین، والأكفاء إلى رجال ونساء والرجال إلى حكام و محکومین. توجد المرأة المسترقة في الدرجة السفلى ويوجد في الدرجة العليا الحاكم وهو بالضرورة ذكر حر بالغ عاقل. هذا سلم اجتماعي ينطلق من الأقل حرية وينتهي إلى الأكثر قدرة على التصرف شرعًا، وفي نفس الوقت من الأدنى إلى الأكثر مروءة وعقلا. فالحرية هي بالتعريف: الاتفاق مع ما يوحي به الشرع والعقل، الحرية حكم شرعي لكنه في نفس الوقت إثبات واقع مدى قدرة الفرد على تحقيق العقل في حياته، وهذا التطابق بين الشرع والعقل والحرية هو العدل الذي يقوم عليه الكون.
أما عن الأخلاق وعلم الكلام فنجد أن قضية الحرية تطرح من زاويتين: الأولى زاوية علاقة العقل بالنفس أو الروح بالطبيعة. ويصاغ السؤال هكذا: هل يستطيع العقل أن يتغلب على النفس ويغير ميولها الطبيعية؟ والثانية زاوية علاقة الإرادة الفردية بالمشيئة الإلهية. ويصاغ السؤال هكذا: هل يمكن أن تعارض الأولى الثانية؟ تتعدد الأجوبة على هذين السؤالين بتعدد المدارس والآراء، غير أن غالبية المسلمين اتخذوا في النهاية خطًا وسطا عبرت عنه بكل وضوح المدرسة الأشعرية.
إن التجربة الإسلامية أغنى بكثير مما يوحي به القاموس العربي الذي سجل استعمال الفقهاء، ولم يجد المستعربون مفهوم الحرية الأصلية الشاملة المطلقة في اللغة فظنوا أن النقص يدل على انعدام ممارسة الحرية وعلى غياب الشعور بضرورة الحرية. هذان الاستنتاجات خاطئان. فإلى جانب قاموس الكلمات - وهو قاموس الثقافة. يوجد قاموس الرموز الذي هو قاموس التاريخ الفعلي وهو أكمل من الأول. بحثنا نحن عن تلك الرموز ووجدنا أربعة، كل واحد منها يعبر عن مؤسسة اجتماعية، عن دعوة أخلاقية، عن مثل أعلى، وعن نفسانية نوعية. تشير التقوى إلى حرية فردية داخل الدولة ويذهب التصوف إلى أقصى مدى في هذا الاتجاه ليتصور ملامح الحرية المطلقة خارج الدولة.
2- الدعوة إلى الحرية (عهد التنظيمات)
كان المجتمع العربي التقليدي يتميز بشكل من أشكال التوازن، بين البداوة والعشيرة والدولة والفرد. تمثل البداوة حرية الأصل، السابقة للدولة، وتمثل العشيرة المحافظة على بعض حرية التصرف داخل الدولة، ويستطيع الفرد أن يلجأ إلى التصوف الذي يخرجه نهائيًا عن مجال السلطان.
أما المجتمع السياسي فكان يتميز بالاستبداد المطلق؛ لكن مجاله كان ضيقًا. كانت الحرية مجرد طموح داخل المجتمع السياسي لكن المجتمع السياسي لم يكن يطابق المجتمع العربي مطابقة تامة وكان الفرد يستطيع أن يناهضه من وراء إحدى الجماعات التي ينتمي إليها، ويستطيع كذلك أن ينسحب منه نهائيًا ليعيش مع ذاته ولذاته. في كل ميدان من ميادين الحياة العربية التقليدية نجد اختلافا بين الحرية كفكرة والحرية كممارسة. نجد الوعي الدقيق بالحرية وهي مفقودة، لكن بعيدة كل البعد عن التمثل والوعي.
وطوال القرن الثامن عشر، كانت تحدث تحولات في المجتمع العربي الإسلامي. اتسع نطاق الدولة واضمحل نطاق اللادولة، فضاق مجال الممارسة اللامشروطة اللاواعية واتسع مجال الوعي بضرورة الحرية المجردة المطلقة. نشأت هذه التطورات من جراء توسيع نطاق الدولة. فالحركة التي تعرف في كتب التاريخ باسم الإصلاح أو سياسة التنظيمات، كانت تهدف أساسا إلى تقوية الدولة إزاء تحديات الدول الأوروبية الاستعمارية. فنتج عن ذلك ضغط على الجماعات وعلى الفرد. أصبحت الجماعة المستقلة عدوة يجب إخضاعها بكل الوسائل قبل أن يتصل بها العدو الاستعماري ويستغلها لمصلحته. وأصبح الفرد الحر المستقل عدو يجب دمجه في الدولة بشتى الوسائل لأن في استقلاله إذعانًا للدولة وفي اندماجه تقوية لها.
وبما أن العادات كانت تمثل امتیازات تتمتع بها الجماعات والعشائر، وبما أن الدولة تريد التسوية بين الجميع؛ فقد اتجهت سياسة الإصلاح إلى نقض العادات بقوانين متعددة ومفصلة. وأصبح الفرد الذي لم تعد العشائر تحميه حماية كافية يواجه حدودًا متنوعة، يرجع بعضها الي الطبيعة الخارجية، وبعضها إلى النفس، وبعضها إلى الشرع، وبعضها إلى الأوامر السلطانية ، فأصبحت التجربة الفردية تكاد تدور كلها في نطاق الدولة وتكاد تكون جميع الحدود راجعة إلى أوامر سلطانية.
سبق وقلنا أن الدولة - في عهد سياسات التنظيم- تكثر التشريعات لتنفي الحقوق المكتسبة تحت ستار العادات، ولتصل إلى الفرد من وراء العشائر. وفي مرحلة ثانية نرى الفرد نفسه يعين الدولة في هذه العملية، يخرج هو نفسه من حماه ليواجه الدولة وحيدًا أعزلًا.
إن أصل هذه التطورات هو سياسة الدولة الإصلاحية، وأصل السياسة الإصلاحية الخطر الأجنبي المتمثل في الضغط الأوروبي على البلاد الإسلامية. كان الخطر الاستعماري موجها إلى الدولة التي كانت تمثل الدرع الواقي الذي يحمي المسلمين أفرادًا وجماعات. وكان المسلمون مستهدفين للخطر بصفتهم مسلمين ومنتجين. انقلبت مؤقتا النظرة الي الدولة حينذاك: لم تعد العدو السياسي الذي تحاربه الجماعات لحماية الأفراد؛ بل أصبحت الدولة عند الجماعة هي الجامعة التي تحمي المسلمين من الأعداء. ولهذا انهارت أمامها كل الجماعات الجزئية، من أسرة وحنطة وعشيرة. ولم تنجح سياسة الإصلاح بالقدر الكافي ولم تمنع الدول الغربية الاستعمارية من اكتساح الوطن العربي؛ لكن الدولة العربية الحديثة نجحت في الداخل وقضت على الحواجز التي كانت تفصلها عن الفرد. على الأقل هذا هو الاتجاه العام، مع تفاوت في النتائج من بلد إلى بلد.
بعد هذا العرض السريع للتطورات الاجتماعية التي عرفها المجتمع الإسلامي في أواخر القرن الثامن عشر وطوال القرن التاسع عشر، نفهم بسهولة كيف اكتسح مفهوم الحرية مجال الإدراك وانتشرت كلمة حرية في مجالاته الخطابية والتعبيرية. وبقدر ما كانت الدولة توشك أن تغطي المجتمع بأكمله، بقدر ما أصبحت التجربة الإنسانية كلها تجربة سياسية مرتبطة أساسًا بالدولة. وبما أن الدولة تهدف إلى أن تكون شاملة ومستبدة، فإن معاناة الحدود المفروضة على التصرف لا تنفك تتسع وتتنوع.
3- الحرية الليبرالية
4- نظرية الحرية
5- اجتماعيات الحرية
اكمل قراءة الملخص كاملاً علي التطبيق الان
ملخصات مشابهة
ثقف نفسك بخطة قراءة من ملخصات كتب المعرفة المهمة
هذه الخطة لتثقيف نفسك و بناء معرفتك أُعدت بعناية حسب اهتماماتك في مجالات المعرفة المختلفة و تتطور مع تطور مستواك, بعد ذلك ستخوض اختبارات فيما قرأت لتحديد مستواك الثقافي الحالي و التأكد من تقدم مستواك المعرفي مع الوقت
حمل التطبيق الان، و زد ثقتك في نفسك، و امتلك معرفة حقيقية تكسبك قدرة علي النقاش و الحوار بقراءة اكثر من ٤٣٠ ملخص لاهم الكتب العربية الان