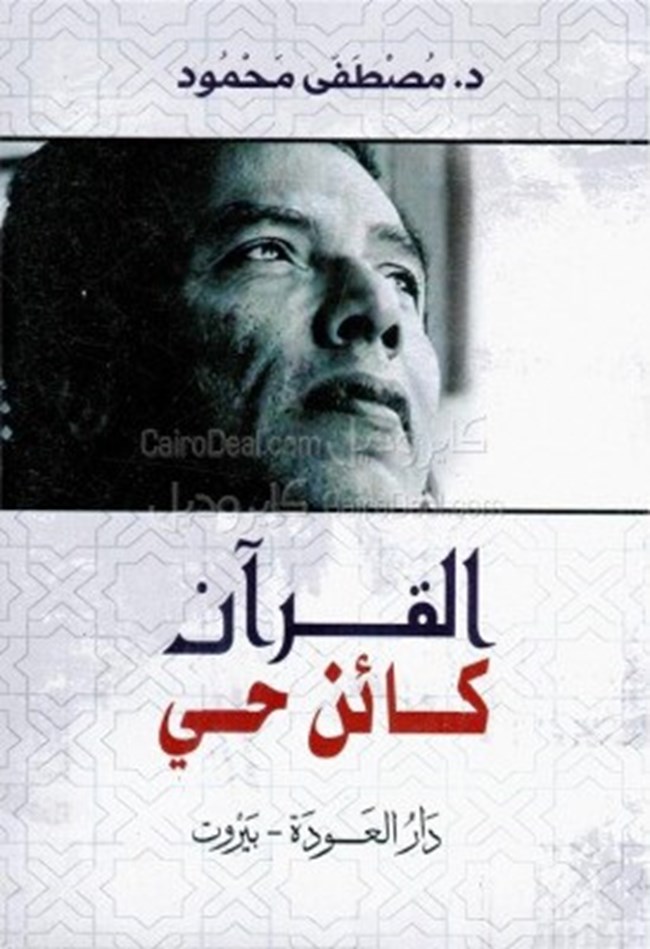ثقف نفسك بخطة قراءة من ملخصات كتب المعرفة المهمة
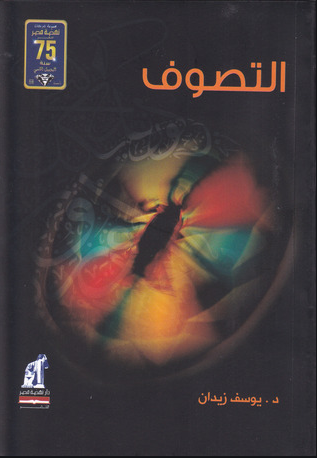
ملخص كتاب التصوف
تعريف بالتصوف وأشهر الطرق الصوفية
يوسف زيدان
للتصوف مفهومٌ من الاتساع بحيث لا تكاد اللغة تحيط به؛ فآونة يرادف العلو ويقصد به الارتقاء بالخبرة الدينية لمستوى أعلى من ظاهر العبادات، وقد يراد به التعبير عن التعمُّق في التجربة الإنسانية وهو يرتبط بالدين وربما ارتبط بالدنيا. ولو أخذنا في التصوف باعتباره إبداعًا إنسانيًّا متميزًا ظهر في الحضارات الإنسانية كافة، لكان من المستحيل تعريفه؛ فقد ظهر عند الهنود وكان مرادفًا للترقي الروحي، وتجلى في التراث المصري القديم باسم الكهانة، وعرفه قدامي اليهود باسم القبَّالى والمسلمون عرَّفوه باسم التصوف، وكلها تسميات دالة على جوهر واحد وهو محاولة الإنسان الوصول من الإرض إلى السماء ومن الوهم إلى الحقيقة ومن هنا سوف نقتصر على تناول مفهوم التصوف ودلالاته عند المسلمين.
1- التصوف
أفرد مؤرخو التصوف فصولاً عديدة للبحث في أصل كلمة التصوف من خلال مجموعة تعريفات ومفاهيم، تسعى للكشف عن طبيعة التسمية واشتقاقاتها ومنها القول بكون التصوف مشتقًّا من الصوف الذي كان رداء الأنبياء والزُّهَّاد، والذي يدل على التقشُّف. والقول بكونه نسبة إلى أهل الصُّفة وهم جماعة من فقراء الصحابة انقطعوا للعبادة في المسجد النبوي بالمدينة. والقول بكونه مشتقًّا من الكلمة اليونانية (سوفيا) وتعني الحكمة.
ومع ما تثيره هذه الأصول المتعددة للتسمية من نقاش في كتب المؤرِّخين والدراسين، فنحن نرى الخلاف حول طبيعة اسم التصوف، خلافًا لا طائلَ منه؛ فالأرجح عندنا ما قاله (القُشيري ) من أن هذا الاسم :"لا يشهد له من حيث اللغة قياسٌ ولا اشتثاق فالأظهر أنه كاللَّقب " .
يمكننا تحديد مفهوم التصوف من خلال هذه المجموعة المختارة من تعريفات التصوف التي ترسم النزوع الروحي ومنها ما يقول (الكرخي ): " التصوف، الأخْذُ بالحقَائِقِ واليَأسُ مِمَّا في أَيْدي الخلائِق" والمراد هنا أن للأشياء على الحقيقة ظاهرٌ وباطنٌ وغالبًا ما يكون الظاهر مخادعًا وباطلاً؛ فالتصوف غوصٌ دائم وراء ما يحتجب وراء الأشكال التعبدية الظاهرة؛ فالتصوف على هذا النحو، أخذُ بالحقائق من مأخذها الصحيح. وهو أيضًا كما يَرِدُ في الشق الثاني من التعريف يأسٌ مما في أيدي الخلائق، وهنا إشارة إلى الفرق بين ما هو بيد الناس، وما هو بيد الله؛ فالناس بأيديهم الوهم والزوال والمادة والله يملك ما يليق بجلاله.
والتعريف الثاني (لأبي بكر الكتَّاني ) ويقول "التصوف خُلُق؛ فَمِنْ زَادَ عَليكَ فِي الخلُق؛ فقد زَادَ عَليكَ في الصَّفَاءِ" وهنا لابد من إيضاح إن للتصوف جانبان أساسيان، الأول يتمثل في الرابطة بين العبد وربه، والثاني يتجلى في العلاقة بين الصوفي وسائر الخلائق؛ فللصوفي مع ربه أخلاق لعل أهمَّها الحياء؛ فلابد إذن من أن يكون حياؤه من الله عظيمًا، وهو الذي يعبد الله كأنه يراه وعلى هذه النظرية تجري بقية أخلاقيات الصوفي مع ربه، وللصوفي مع الخلائق أخلاقٌ تستكمل الجانب الآخر من التجربة الصوفية الصادقة؛ فهو يخالق الناس بالأخلاق الإلهية، فإذا ما سقطت عنه أوصاف العبودية، تتحلَّي نفسه بالأخلاق الربانية الكريمة.
إن هذه التعريفات التي اخترناها فيما سبق، تظلُّ أوليًة من حيث اقتصارها على الدلالات المبكرة، وكلها منسوبة إلى أوائل الصوفية مثل (القشيري ) في رسالته، و(الكلاباذي ) في كتابه (التعُّرف لمذهب أهل التصُّوف )، وقد أصبح التصوف معنًّي مركبًا لا يمكن اختزاله في تعريف أولي وأفاض مشايخ الصوفية في تبيان معنى الكلمة؛ فنرى الإمام (عبدالقادر الجيلاني ) يقول: "المتصوف هو الذي يتكلَّف أن يكون صوفيا ويتوصل بجهد إلى أن يكون صوفيًّا، والصوفي مأخوذٌ من المصافاة، يعني عبداً صافاه الحق عز وجل " ثم يشير (الإمام الجيلاني ) إلى المراتب التي يقطعها الصوفي في سيره إلى الله، فأولها مكابدة النفس والهوى، ثم التعبٌّد وتصفية الباطن، ثم الخروج عن زخرف الأكوان، والتجوهر لرب الأنام والرضا بقضائه فيصير كإناء بلَّوز مملوء ماء صافياً؛ فحينئٍد يُسمَّي صوفيًّا، عارفًا بنفسه وربه.
2- الطرق الصوفية
1- القَلندريَّة :
توصف القَلندريَّة بإنها جماعةٌ أو اتجاهٌ من الاتجاهات التي ظهرت في تاريخ التصوف وارتبطت على نحو ما بالملامتيه فالاتجاه الملامتي هو الأصل الذي تفرَّع عنه اتجاه القَلندريَّة، والملامتيه أسلوبٌ في التصوف، جعل أكبر همه لوم النفس؛ فوفقًا للنظرة الصوفية؛ فإن النفس الإنسانية هي مصدر الغواية والتعلق الدنيوي. ومن هنا أفاض مشاهير الصوفية في الكلام على ضرورة مجاهدة النفس، لضمان النجاة من رعونتها، والمراد بالنفس فيما سبق، النفس الأمارة بالسوء، فإذا جاهدها صاحبها انتقلت إلى مرحلة أعلى هي مرتبة النفس اللوَّامة، وقد اشتق اسم الملامتية من الملامة، بمعنى لوم الشخص لنفسه، ولوم الناس له.
وكان أول من نشر الاتجاه الملامتي، هو (حمدون القَصَّار ) وكان من أهل نيسابور وقد نقل عنه (الهجويري ) قوله: "الملامة ترك السلامة"، إلى أن مؤسِّسي هذا الاتجاه ثلاثةٌ: (أبوحفص عمرو بن سلمى ) و(سعيد بن إسماعيل الواعظ ) و(حمدون القَصَّار ) وقد ظهرت القلندرية أولا ببلاد فارس، ثم انتشرت في أرجاء العالم، فقد كان أول ظهور للقلندريين في دمشق، وحضرت إلى مصر مع فقيرٌ فارسي يسمى (حسن الجولقي ) وأسس زاوية قلندرية، وقد بدأ انتشار القلندرية منذ وقٍت مبكر، كامتدادٍ للاتجاه الملامتي، ثم توالى ظهور القلندرية في المدن الإسلامية حتى القرون الأخيرة وتأسس لهم عدة زوايا في مصر والشام وتركيا.
المبالغة في الملامة، القلندرية:
مع أن التوغل في الاتجاه الملامتي، والمبالغة فيه قد يقودان إلى القلندرية، فإن (الملامتية ) حظيت دومًا بتقدير مشايخ التصوف بينما نظر إلى (القلندرية ) نظرة ازدراء، والفرق بين الملامتي والقلندري بحسب ما يوضَّحه لنا (السهروردي ) في (العوارف ) هو أن الملامتي يعمل في كتم العبادات والقلندري يعمل في تخريب العادات، الملامتي يتمسَّك بكل أبواب البر والخير، ولكن يُخفي الأعمال والأحوال، أما القلندري لا يعوِّل إلا على طيبة القلوب والتيقُّن الذاتي من صلاح الحال، والصوفي عند (السهروردي ) هو من يضع الأشياء مواضعها ويدبِّر الأوقات والأحوال كلها بالعالم، يقيم الخلق مقامة ويقيم أمر الحق مقامهم، ويأتي بالأمور في موضعها، بحضو عقل وصحة توحيد ورعاية وإخلاص.
3- القادرية
4- الدُّسُوقِيةُ
5- الشاذلية
6- العزمية :
7- البرهانية
اكمل قراءة الملخص كاملاً علي التطبيق الان
ملخصات مشابهة
ثقف نفسك بخطة قراءة من ملخصات كتب المعرفة المهمة
هذه الخطة لتثقيف نفسك و بناء معرفتك أُعدت بعناية حسب اهتماماتك في مجالات المعرفة المختلفة و تتطور مع تطور مستواك, بعد ذلك ستخوض اختبارات فيما قرأت لتحديد مستواك الثقافي الحالي و التأكد من تقدم مستواك المعرفي مع الوقت
حمل التطبيق الان، و زد ثقتك في نفسك، و امتلك معرفة حقيقية تكسبك قدرة علي النقاش و الحوار بقراءة اكثر من ٤٣٠ ملخص لاهم الكتب العربية الان